لتحسين عملية التعلم بشكل حقيقي، يجب على المدارس التوقف عن المحاولة جاهدة
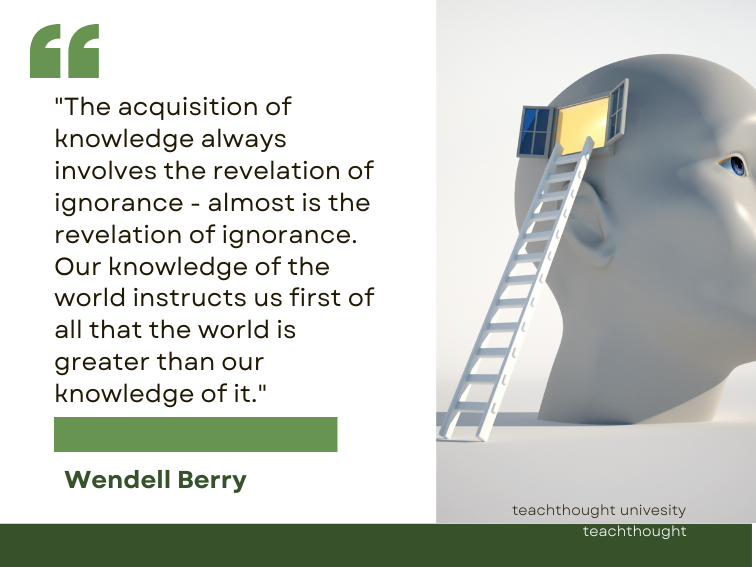
بواسطة تيري هيك
التعليم عبارة عن سلسلة من خبرات التعلم المستنيرة بالسياسة، والتي يحركها المعلمون.
إن السياسة، بطبيعتها، كاسحة وطموحة. لقد تم تصميمه للعمل على مستويات مختلفة، وهو حسن النية، وغالبًا ما يصعب الخطأ فيه على الورق. المعلمون لا يختلفون كثيرًا حقًا. إنهم طموحون، ومصممون للعمل على مستويات مختلفة، ومكلفون (بالمعنى الحرفي للكلمة) بسن السياسات التي تحكم المؤسسات (المدارس) التي يعملون فيها.
ومع ذلك، تظهر التجاعيد عندما يسعى المعلمون إلى تحقيق رؤية للتعليم مستحيلة تمامًا، كما هي الحال الآن: أن يتقن كل طالب كل المعايير الأكاديمية.
بغض النظر عن مستوى معرفة القراءة والكتابة في البداية، أو الذكاء العاطفي، أو الأهداف في الحياة، أو التاريخ العائلي، أو الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، أو عادات التعلم والتفكير، أو الطموح الأكاديمي، فإن النتيجة نفسها متوقعة من جميع الطلاب – وكلمات مزعجة بشكل متزايد مليئة بالدلالات والتضمين.
الكفاءة.
ولعل الأسوأ من ذلك كله هو أن هذا المقياس الشامل للكفاءة لا يعتبر شرًا لا بد منه، بل أنبل الأهداف – المساواة التي تتجلى في الديمقراطية نفسها.
المساواة في التعلم
المساواة في التعلم يمكن أن تعني أي شيء. نفس الإنفاق. نفس الموارد – أو بالأحرى نفس تلبية الاحتياجات النسبية. نفس التوقعات.
لا يعني العدل دائمًا المساواة، كما قد يفكر الكثيرون بشكل صحيح، ولكن بينما نسعى لإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التعلم، ينتهي بنا الأمر إلى استجابات مكتوبة لظروف غير مكتوبة، ونتيجة لذلك، يتم تجانس شيء لا علاقة له به.
تعلُّم
لكن المساواة في التعلم هي مطاردة خطيرة، مليئة بالطرق المسدودة، والخطابة، وفي بعض الأحيان، التبذير.
التعلم فوضوي وشخصي – فوضوي لأن انها شخصية، في الواقع. وهو إسراف للعديد من الأسباب نفسها. ليس لأن الناس يتعلمون بشكل مختلف، ولكن لأن التعليم غالبا ما يحاول فرض “التشابه” على كل شيء. وعندما لا ينجح هذا النهج، يتم إنفاق كميات كبيرة من الموارد في استكشاف الأخطاء وإصلاحها و”المعالجة” وتعقب الأخطاء السابقة.
يمكن أن يكون التعلم محبطًا لنفس الأسباب التي تجعله مقنعًا – لأنه غريزي وبدائي. يبدأ الأمر كلعبة، ثم يتحول سريعًا إلى شكل أكثر رسمية عندما يتحول التجريب الموجه ذاتيًا إلى بيئة أكاديمية عقيمة. المدارس ذات النوايا الحسنة تهتم كثيرًا بالتعلم لدرجة أنها تسحب كل توقف: صفارات الإنذار، والعدادات، وصمامات التنفيس لإعلامنا بما يحدث في جميع الأوقات.
ومع ذلك، يعد هذا جزءًا (صغيرًا) من المشكلة، مثل التحقق من قواعد التقييم والبيانات خلال موعدك الأول لمعرفة كيف تسير الأمور. هذا لا يعني أنه لا يوجد مكان للبيانات ونماذج التقييم، ولكن قد يكون الأمر أننا وجدنا حوافًا باهتة في سعينا لتحقيق الكفاءة.
وفي السعي لتحقيق التميز وجدنا الرداءة.
ليست حجة لنماذج التعلم
في هذه المرحلة، عادة ما يتحول الحديث إلى نماذج التعلم – تعلم ريادة الأعمال، التعلم الذاتيالتعلم المتنقل، التعلم القائم على اللعب، التعلم القائم على المشاريع، التعلم القائم على التحقيق، التعلم المختلط.
وما إلى ذلك وهلم جرا.
وهذا كله وثيق الصلة بالموضوع ومفيد، وكله يصرخ من أجل التفكير والتكامل والمراجعة. ولكن بدلاً من ذلك، قد يكون التركيز الأكثر إلحاحًا في نطاقنا هو الطريقة التي يتعارض بها المعلمون وأنظمة المعلمين مع بعضهم البعض في الغالبية العظمى من المدارس العامة اليوم.
الأنظمة
إذن ما هي هذه “الأنظمة”؟
إرشادات المنطقة و”غير القابلة للتفاوض”.
خطط النمو المهني.
مجتمعات التعلم المهنية.
فرق البيانات.
التطوير المهني الذي ترعاه المنطقة والمدرسة.
نشر وسائل الإعلام لنتائج الاختبارات.
في الواقع، دعونا نتوقف وننظر إلى ذلك للحظة.
الإبلاغ العام عن نتائج الاختبار
إن نشر نتائج الاختبارات ليس هو المشكلة، بل هو الفراغ الذي يواجهه معظم الأشخاص لاستيعاب تلك البيانات. يرى الجمهور بمصطلحات أكثر ثنائية-مدرسة فاشلة و أداء المدرسة. ربما تحسين المدرسة. هذا كل شيء.
أبداً فشل امتحان، أداء الاهتمام بمحو الأمية، أو في إزدياد دعم المجتمع. لا يُنظر إلى المدارس على أنها مترابطة بشكل كامل مع المجتمع، بل هي مصانع للأدوات، وبالتالي يتم الحكم عليها من خلال أدواتها. وربما الأسوأ من ذلك كله هو أن هذه الأدوات هي أطفال.
السبب وراء هذه المشكلة يتعلق بالدلالة واللغة المحملة بالحيل الإعلانية للحرس القديم لجذب الناس إلى الاهتمام. إن القطعة باردة، لكن الطفل هو شيء حي، يتنفس، وامض ويستحق أفضل مستقبل ممكن – وأفضل ما نقدمه اليوم للمساعدة في تحقيق ذلك.
وبالطبع هذا صحيح.
لغة غامضة ومحملة عاطفيا
لذلك عندما نتحدث، يمكن أن تكون لغتنا فارغة ومعممة. نتحدث عن المستقبل والتعلم من نيتنا الجماعية التي لا تتزعزع في “فعل الصواب من أجل هؤلاء الأطفال”. نحن نتخذ القرارات “الأفضل للأطفال” بدلاً من البالغين، لأنه من من البالغين قد يقترح العكس؟
ولكن من خلال هذا الطموح غير الأناني والعظمة القائمة على الشفقة، فإننا نضع أنفسنا في المشاكل. نحن ببساطة لا نستطيع أن نفي بوعودنا باستمرار، ونلجأ، في حيرة من أمرنا، إلى التطوير المهني لحل مشاكلنا.
إذا كانت المدرسة نظيرًا لصناعية ما بعد الحداثة – ولا ينبغي أن تكون كذلك، ولكنها تعمل حاليًا على هذا النحو بالضبط – فإن المعلمين والإداريين هم الذين يديرون الروافع والمطابع. نحن نصنع القوالب، ونملأ الناقلات بالأدوات، ونملأ المنصات، ونشغل الرافعات الشوكية، وندون ملاحظات جدية للغاية على حافظاتنا بينما نشاهد بأعين جدية بنفس القدر.
لكن المعلمين والإداريين، الذين يخططون ويراجعون بلا كلل بينما تتأرجح العملية برمتها، هم الذين يصدرون أصواتًا وأصواتًا. نحن نعد ونقسم في كل من العقيدة والسياسة بمساعدة كل طفل على تحقيق إمكاناته كبشر. الضغط والغطرسة لهذا الوعد!
نضيف توقيعات تمكينية على بريدنا الإلكتروني، “الفشل ليس خيارًا”، أو “إعداد الأطفال للمستقبل”، ومن ثم “إعادة شحن بطارياتنا” خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات حتى نتمكن بعد ظهر يوم الاثنين من الجلوس في اجتماعات الموظفين لمدة ساعتين التي تحرمنا من أي قدر من روح الابتكار التي تمكنا من استعادتها.
نحن ندعو أولياء الأمور إلى المدرسة كل ثلاثة أشهر مع وعد ببيع المخبوزات أو مسرحية مدرسية وغيرها من الأحداث اللامنهجية، متظاهرين بعدم ملاحظة مدى حرج الأمر برمته – كيف نقوم بتربية أجزاء مختلفة من أطفالهم ولكننا بالكاد نعرف بعضنا البعض.
كيف نستمر بعناد في تعليم الأطفال بينما تنتج الصناعة السلع.
كيف نفشل في ربط المنظمات بالأسر والمدارس والجامعات والبرامج الثقافية والمراكز المجتمعية بأي طريقة مقنعة لأننا، كمدارس، نصر على الذهاب بمفردنا، ولا نفتح الأبواب إلا وفقًا لجدولنا الزمني وشروطنا لمساعدتنا على القيام بما نريد للقيام به لأننا كتبنا الكتاب حول ما يجب القيام به.
نحن نستخدم لغة وعمليات تعليمية غريبة تمامًا على معظم العائلات. وفي هذه العملية، نقوم بإنشاء نظام تعليمي غير مستدام تمامًا – وخاصة بشكل سيء – يقلل من قدرة العائلات والمجتمعات بينما نكدح في استشهاد فخور، دون أن ندرك أبدًا أن طموحنا يكلفنا كل شيء.
إذا كانت المدارس تخدم الطلاب، وكان الطلاب مندمجين بعمق في نسيج المجتمعات، فكيف يمكننا أن نخدم هؤلاء الطلاب دون معرفة تلك المجتمعات؟ ودون أن تعرفنا تلك المجتمعات؟
ربما نفتح أبواب مدرستنا وفصولنا الدراسية للتفاعل الهادف مع العائلات والمجتمعات على قدم المساواة، ليس على المستوى اللامنهجي، بل على مستوى المنهج الدراسي.
إن قول ذلك أسهل بكثير من فعله، لكن المحادثات حول تحسين المدرسة يمكن أن تكون أسوأ من البدء بها.
بالضبط من أين نبدأ بتحسين المدرسة





